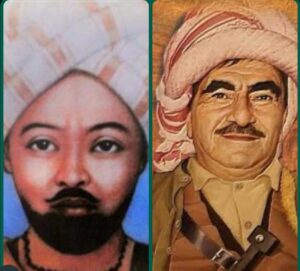أسماء محمد: تفكيك الدولة والإنسان .. تركة الحركة الإسلاموية في السودان ومسارات الخروج من أزماتها!!

بقلم: أسماء محمد جمعة
شكّل حكم الحركة الإسلاموية في السودان، الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، نموذجًا معقدًا لتداخل الدين بالسلطة وتسييس الهوية في سياق من الاضطراب البنيوي. لم تقتصر تأثيرات هذا الحكم على البنية السياسية والاقتصادية فحسب، بل تسللت عميقًا إلى نسيج الوعي الجمعي، حيث جرى توظيف مؤسسات الدولة كأدوات لإعادة تشكيل الإدراك الاجتماعي والنفسي وفق منطق السيطرة. وقد أدت الحروب الأهلية، وآليات القمع المؤسسي، وسياسات الإقصاء، إلى جانب التدهور الاقتصادي المتعمد، إلى تفكيك الرابط النفسي بين المواطن والدولة، ما أفرز حالة من “الانشطار النفسي الجمعي” تجلت في انتشار الاغتراب، وانعدام الثقة، والتطبيع مع العنف كجزء من التجربة اليومية.
في هذا السياق، وفي ظل غياب معايير العدالة الموضوعية، جرى تفريغ القانون من مضمونه ليُعاد تشكيله كأداة لضبط الولاء السياسي والديني وليس لضمان الحقوق. تحوّل الانتماء الحزبي إلى شرط ضمني للمواطنة الكاملة، بينما جرى تهميش الكفاءة وتحييد الاستحقاق. هذا الواقع أسس لحالة من الإقصاء الممنهج، انعكست في ارتفاع معدلات الأمراض النفسية، وظهور سلوكيات سلبية تعكس أزمة هوية واغتراب، استخدمها الأفراد كآليات دفاعية للهروب من واقع ضاغط وبيئة طاردة للطاقات والأحلام. وقد أسهم هذا التهميش المنظم في تفكك الهوية الفردية، وتمزّق الرابط بين الذات والمجتمع، مما عمّق مظاهر الاغتراب وكرّس الانفصال الوجداني عن الدولة.
ولعب الإعلام الرسمي دورًا محوريًا في هذا المشهد، فلم يكن مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية لتفكيك البنية النفسية والاجتماعية. من خلال خطاب ممنهج، أعاد الإعلام تشكيل الوعي الجمعي على أسس إقصائية، بتكريس مفهوم “العدو الداخلي” وتوجيه الاتهام نحو المثقفين، النساء، والمكونات العرقية . وقد بلغ هذا النهج ذروته في تغطيات جرائم الكثير من الجرائم ، حيث جرى تبرير مكثف للعنف، مما كشف عن انهيار مزدوج: أخلاقي في مؤسسات الدولة، ونفسي في بنية الجماعة الوطنية.
أما الأطفال والشباب، فقد عاشوا تجربة مريرة من التدهور المزدوج: فقدان الحماية الاجتماعية والتعليمية، من جهة، وتجربة التجييش القسري والاستغلال الديني المتطرف من جهة أخرى. نشأت أجيال في بيئة امتزج فيها العنف بالعقيدة، مما جعلهم فريسة سهلة للاستقطاب من قبل أي مشروع أيديولوجي متشدد. وبفعل هذه التجربة، تعرضوا لتشويه نفسي عميق قوض قدرتهم على بناء هوية وطنية مستقلة، وأنتج فئات اجتماعية مفككة، عاجزة عن التفكير النقدي، وأكثر عرضة للاستغلال.
هذه الحالة تُعد من أخطر الموروثات النفسية التي خلفتها المرحلة، إذ تهدد الأمان الوجودي للأطفال والشباب، وتنعكس سلبًا على قدرتهم على التكيف والنمو السليم، بما يؤثر على تطور المجتمع بأكمله. فهي أزمة طويلة الأمد تمس النسيج الاجتماعي والنفسي للأجيال القادمة، وتعيق بناء مستقبل يقوم على الثقة والتماسك.
من جهة أخرى، اختارت الحركة الإسلاموية الحرب بدلاً من الحل السلمي، لأنها رأت في أي انتقال ديمقراطي تهديدًا لبنيتها السلطوية القائمة على الإقصاء والاستبداد. فالاتفاق على تسوية سياسية كان يعني تفكيك آليات التمكين، وكشف الانتهاكات، وإعادة تعريف المواطنة على أسس العدالة لا الولاء. ولحشد التأييد، لجأت السلطة إلى استراتيجيات تضليل نفسي متكررة، عبر تعبئة إعلامية تغذي الخوف والانقسام، وتوظف الدين لتجريم الآخر وتصوير الثورة كفوضى ودعاة الإصلاح كعملاء . في ظل هذا المشهد، انقسم الوعي الجمعي بين ضحية غير واعٍ وأحيانًا متواطئ، وفاعل مهيمن. فبفعل الاستقطاب والانهيار النفسي الناجم عن القمع، انخدع البعض بخطاب “الاستقرار بالقوة”، ووقفوا إلى جانب من تسببوا في معاناتهم ليحكموهم اكثر من ثلاثة عقود، في مفارقة تعكس حجم التشويه النفسي العميق في الذات السودانية.
للخروج من أزمة الحركة الإسلاموية في السودان وتحقيق التعافي الوطني الكامل، لا بد من مقاربة شاملة وجذرية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، وتتوجه نحو تفكيك المنظومة القمعية التي أرستها الحركة عبر عقود. هذا التفكيك لا يمكن أن يتم دون محاسبة حقيقية تطال المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت، من خلال مسار عدالة انتقالية واضح، يتضمن محاكمات علنية، وكشفًا للحقيقة، ومحاسبةً لا تقبل الانتقاء، إلى جانب تفكيك آليات التمكين التي زرعت داخل المؤسسات الأمنية، والقضائية، والاقتصادية.
لكن المعالجة لا يجب أن تقف عند البنية الصلبة للتمكين، بل ينبغي أن تمتد إلى البنية الناعمة التي استخدمتها الحركة لترسيخ مشروعها، مثل الخطاب الديني والإعلامي، والمناهج التعليمية، والمؤسسات الدينية التي تحولت إلى أدوات دعائية. إصلاح هذه المسارات يتطلب تحريرًا للعقل الديني من أسر التفسير الإقصائي، وبناء خطاب يرسّخ قيم التسامح، والعدالة، والاعتراف بالتعدد، كمدخل لإعادة التوازن للمجتمع.
كما أن المجتمع نفسه، الذي كان ضحية طويلة لسنوات من التلاعب الفكري والعنف المنظم، يحتاج إلى برامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي، تستعيد ثقته بذاته، وبالفضاء العام، وتحرّره من آثار الخوف والرقابة الداخلية التي فرضتها المنظومة الإسلاموية.
أما الحركة الإسلاموية ذاتها، فلا يمكنها القفز على مسؤوليتها التاريخية. إنكارها المتواصل لجرائمها لن يجدي، والطريق الوحيد لتجنّب صدامٍ عنيف مع الذاكرة الجماعية هو الاعتراف الصريح بالجرائم، وتقديم رموزها للعدالة، ومراجعة فكرها من الداخل بصدق لا تبريري، مع تبني انسحاب سياسي منظم يسمح بمرحلة تعافٍ وطني حقيقية، وتأسيس وطن جديد على قاعدة التنوع والعدالة والمشاركة.
إن الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان دون الاعتراف بالبعد النفسي للأزمة يبقى ناقصًا. فالتعافي الوطني يتطلب عدالة انتقالية شاملة، تشمل المحاسبة القانونية، إلى جانب إصلاحات عميقة في الخطاب التربوي، الإعلامي، والديني. إعادة بناء الوطن تبدأ من ترميم الإنسان السوداني نفسيًا واجتماعيًا، مما يعزز مناعة المجتمع وقدرته على استعادة الثقة بنفسه وبمستقبله.
ولذلك، فإن تجاوز هذه التجربة لا يكفي أن يكون سياسيًا، بل يجب أن يكون مشروعًا وطنيًا شاملًا للشفاء الجماعي، يضع كرامة الإنسان في قلب الفعل السياسي، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والمساواة والاعتراف بالتعددية. إن علاج الجراح النفسية وبناء الثقة بين المكونات المختلفة هو السبيل الوحيد للانتقال من التشظي إلى الوحدة الوطنية، ومن التهديد المستمر إلى مجتمع مستقر ومزدهر.